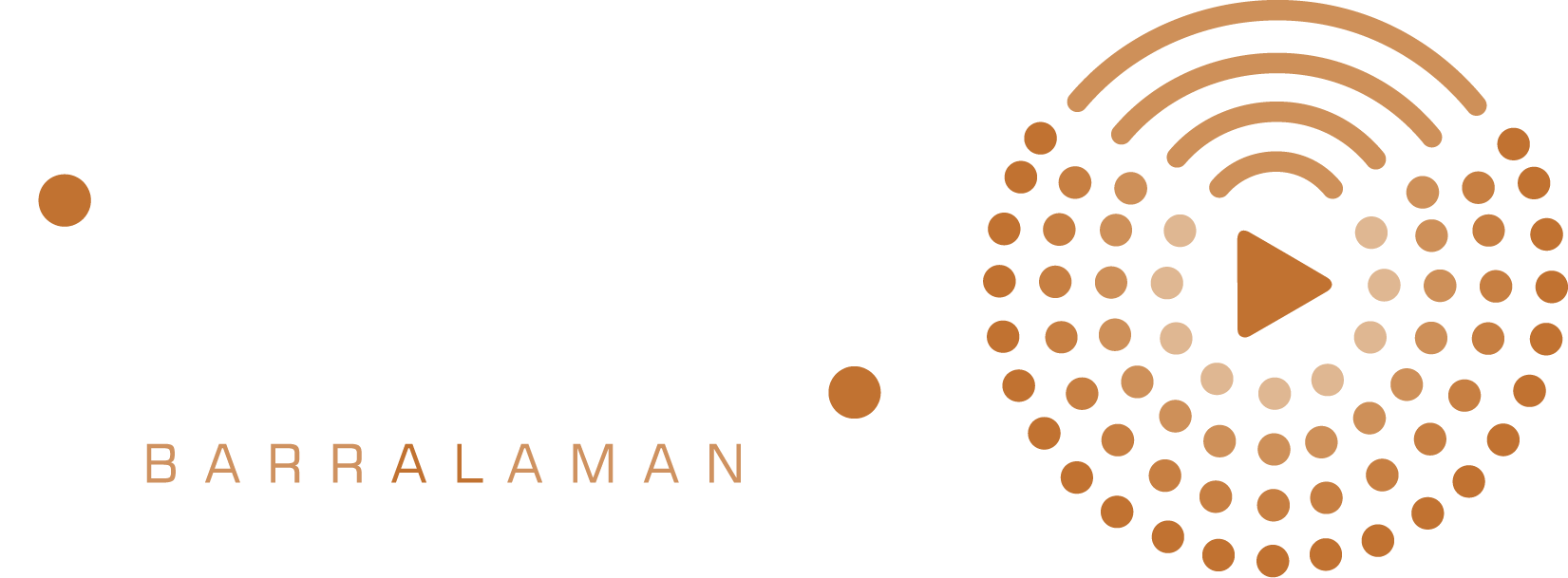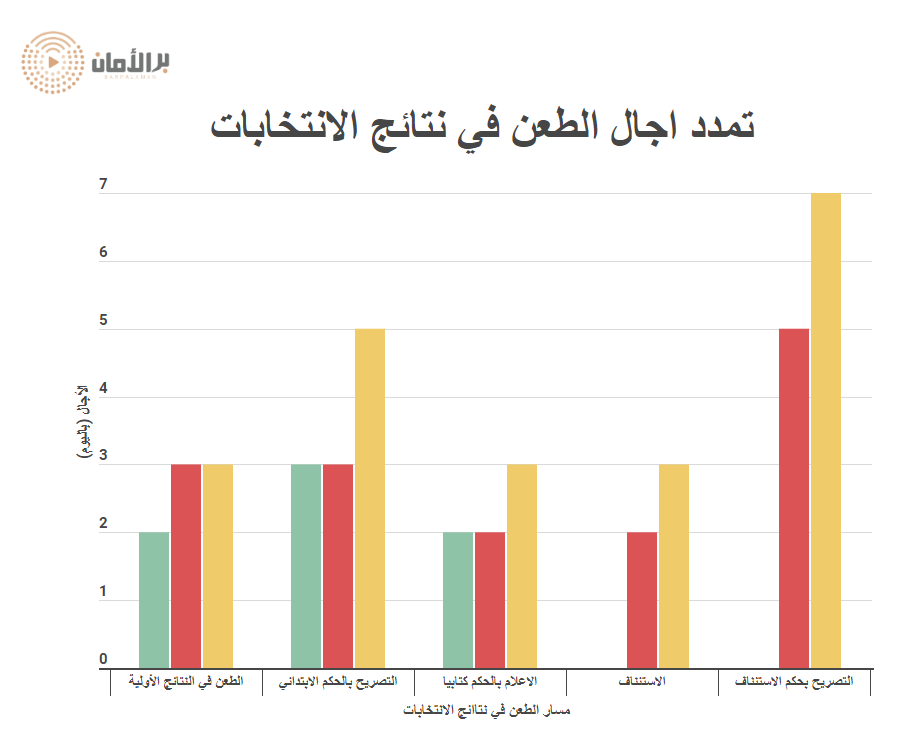Contents
50 مليارا من الدولارات: مبلغ تمّ تكراره مرارا عبر مختلف الوسائل الإعلاميّة كثمن للتنازل عن الحقوق السياسيّة للفلسطينيين. يعبّر هذا الرقم كذلك عن الإرادة الأمميّة للحصول على اتفاق سلام في الشرق الأوسط. فبعد سنتين من الإشاعات حول مضمونه ، كشفت الإدارة الأمريكية الستار أخيرا عن محوره الاقتصاديّ خلال قمّة المنامة بالبحرين (25-26 جوان الماضي) في مشهد سريالي يمتزج فيه الحديث عن الاحتلال بالدولارات و رهانات الديبلوماسيّة العتيقة.
جمود في الأداء
إلى حين نشره في موقع البيت الأبيض،ظلّت “صفقة القرن” الذي تمّ الإعلان عنها عقب تولّي “دونالد ترامب” لمهامه ، موضوعا لغموض دبلوماسي كبير. فمنذ أكثر من سنتين على وجه التحديد، لم يتناه إلى مسامع الصحافيين و المسؤولين الديبلوماسيّين سوى تصريحات مقتضبة من “جاريد كوشنر” (مستشار و صهر ترامب) و “جاسون غرينبالت” (الممثل الخاص للمفاوضات الدوليّة) حول هذه المسألة. لا يوجد سوى هامش ضئيل كي نتوقّع جوهر توجهات هذه المبادرة السياسيّة، و لكنّ هذا الهامش كاف كي نفهم أن الأسرار التي يطويها كتمان الدبلوماسيين الأمريكيين و الإسرائيليّين تدخل في إستراتيجية بالونات الاختبار بشكل ما، إلا أنها لا تعطي كذلك الكثير من المعلومات كي لا تتمكّن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي من طرح مبادرة منافسة جديدة.
كانت العمليّة أول انتصار ل”ترامب”. فإعلانه عن نيّته لإيجاد حلّ لملف النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي المعقد و كأننا نضع حدّا لصراع اقتصادي -باقتراحه لمبالغ تعويضية كبيرة- قد سبّب توترا مع عديد الشركاء الذين لم يتمّ إقناعهم تماما رغم جرأة طرحه الدبلوماسي.
في الأمم المتحدة، كانت قرارات الجمعيّة العامّة التي تدين الاحتلال الإسرائيليّ و التي كانت تؤكّد على ضرورة عدم دفن أي أمل في رؤية دولة فلسطينيّة تتراكم وسط اللامبالاة التامة من قبل الإسرائيليّين. و كانت المنظمة تخضع للهجوم المالي و السياسيّ لترامب ضدّ مؤسساتها بغرض التراجع عن هذه القرارات أو إملاء بعض الإكراهات على خطها السياسي.
فالهيئة الأمميّة المكلفة بشؤون المهجّرين الفلسطينيين (الأونروا) قد شهدت تراجع ميزانيّتها بنسبة 30 بالمائة عقب القرار الأمريكي بعدم ضخ مساهمتها فيه (كانت بحجم 360 مليون دولار سنة 2017 بالنسبة لمجموع الميزانيّة الكامل الذي كان يقارب المليار دولار). و في سنة 2018 قرّرت الولايات المتحدة كذلك الانسحاب من اليونسكو الذي كانت ديونها غير المدفوعة من ميزانيته تقارب ال550 مليون دولار و هو ما يهدد استمرارية هذه المؤسّسة في مقتل.
لقد حمل الاتحاد الأوروبي على عاتقه كامل الدور السياسيّ الذي سمحت به قوّته الاقتصاديّة . و قامت فرنسا مؤخّرا بلعب دورها التقليدي من خلال اقتراح مبادرة انحصرت في إعلان حسن نيّة، كان القرار الإسرائيليّ بعدم المشاركة فيها كفيلا بإجهاضها في المهد.
و بدون أيّة منافسة ديبلوماسيّة حقيقيّة قدّمت الإدارة الأمريكيّة دعائم رؤيتها السياسيّة التي لم تكن للمفارقة سوى وجه مطابق لرؤية حكومة “بنيامين ناتنياهو”، خارج كلّ إطار للتفاوض و التفاهم الدوليّ.
يوم 6 ديسمبر 2017 اعترف دونالد ترامب بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ، و هي خطوة تتعارض مع التوافق الدوليّ الذي يعترف بالقدس الشرقيّة كعاصمة فلسطينية. و كان نقل العاصمة الأمريكيّة يوم 14 ماي 2018 بمناسبة الذكرى السبعين ل”إعلان الكيان الإسرائيلي” ( و هو تاريخ اندلاع النكبة التي طرد فيها أكثر من 800 ألف فلسطيني من أراضيهم) ملمحا رئيسيّا في هذه المبادرة ، التي أشعرت الجميع صراحة بأن القرار الأمريكيّ بإنهاء مسألة تقسيم القدس قد اتّخذ بشكل نهائيّ و أحاديّ ، و هي المسألة التي كانت في القلب من متطلّبات السلام العادل.
و كانت التصريحات المتعاقبة من المسؤولين الأمريكيّيين ك”كوشنر” و “غرينبالت” و كذلك “دافيد فريدمان” ، السفير الأمريكي في “إسرائيل” حول “حقّ” إسرائيل في ضمّ المستوطنات التي أقيمت على أراضي الضفة الغربيّة، عنصرا آخر قد استبق نشر الضوابط السياسيّة لصفقة القرن.و لم يكن الإعلان عن الجانب الاقتصاديّ من الصفقة في نهاية جوان 2019 سوى مؤشّر آخر على هامش المشروع السياسيّ.
و لكي يكتمل هذا المشهد من الأداء الديبلوماسي الموظّف بشدّة لصالح أقصى اليمين الإسرائيليّ، يجب ملاحظة الصمت الأمريكي حول حصار قطاع غزّة و إنهاء الاحتلال و إنشاء الدولة الفلسطينيّة كاملة السيادة. بهذا المعنى فقد نجح ترامب في مزج فنّ السر الديبلوماسي مع الإرادة السياسية الإسرائيليّة بفرض الأمر الواقع. إذ “صفقة القرن” هي قبل كلّ شيء قصّة “في حضرة الغياب”، حيث مكّن غموضها من تخدير الإرادات الديبلوماسيّة و تعزيز الأجندة الإسرائيليّة فوق الأرض.
الاقتصاد الفلسطينيّ :عن ماذا نتحدّث بالضبط؟
يبدو أنّ ذلك الزمن الذي كانت فيه الجامعة العربيّة الموحّدة قادرة على طرح مبادرتها الخاصّة حول السلام الإقليمي (2002)-و الذي تطلّب الرد الإسرائيلي حوله بالنفي 14 سنة لإعلانه – قد ولّى، و دليل ذلك الموقف العربي الحاليّ من صفقة القرن الذي اتّسم بالخضوع أكثر من المشاركة في صياغة المشروع (ناهيك عن المعارضة). و قد كان الحذر الديبلوماسيّ مطروحا أمام إعلان مبلغ ال50 مليار دولار، و في المقامرة كما في السياسة فإن للخداع حدوده الواضحة.
قامت البلدان العربيّة بمضاعفة جهودها و بشكل مبتكر أحيانا للحضور في “ورشة المنامة”، التي سمّيت كذلك للتغطية على فشلها في جمع التمثيليات السياسيّة من الصفّ الأول.فقد حضر عدد من رجال الأعمال و المسؤولين الوزاريّين و كتاب الدولة لتمثيل بلدانهم، و وحدها المملكة العربيّة السعوديّة و قطر و الإمارات العربيّة المتحدة من أرسل تمثيليات على المستوى الوزاريّ (وزراء الماليّة، في علاقة بموضوع القمّة). و لم تستطع الوعود الاستثماريّة غير المسبوقة في تحجيم المعارضة الاجتماعية الضخمة المندّدة “بيع” حق الفلسطينيّين في تقرير مصيرهم.
يمكن تفسير هذا التوجّس ببعض الحسابات السياسيّة للأنظمة الموجودة حاليّا في الحكم ، و التي لا تريد إعطاء حجة إضافيّة جديدة لشعوبها للتمرّد عليها، خصوصا و أن الأنظمة الأوتوقراطيّة في المنطقة كانت غالبا ما تنتهز فرصة الاستعانة بموضوع “القضيّة الفلسطينية كأداة جيدة لدعم مشروعيّتها السياسيّة.
و قد كان البعض من الانجذاب للإعلانات الأمريكيّة يعتمد أساسا على الطابع السرياليّ لمخطّط “من السلم إلى النماء” (الاسم الرسمي الذي تم اختياره للجانب الاقتصاديّ من الصفقة)، حيث يقدّم توصيفا لحالة الاقتصاد الفلسطيني دون أدنى علاقة بواقعه المرتبط به. فالذي يطالع هذا المشروع لا تبتدره أيّ ملامح للعواقب الاقتصاديّة للاحتلال الإسرائيليّ.
لقد حصر التقرير المخصّص للموضوع عوائق النمو الاقتصادي في فلسطين في العجز الحكومي( الذي يجب تداركه لإضفاء حركيّة على القطاع الخاصّ) فضلا عن ضعف الاستثمارات الخارجيّة. و لكي تجعل من الاقتصاد الفلسطينيّ “سنغافورة الشرق الأوسط” كان على الحكومة الأمريكيّة اقتراح تخصيص مبلغ 50 مليار دولار من الاستثمارات على عشر سنوات و إعانة السلطات الحكومية الفلسطينيّة في عمليّة إصلاح ليبراليّة حتّى النخاع.
غير أنّ الاقتصاد الفلسطينيّ يعاني من مشاكل أخرى في الواقع. فالسيطرة الإسرائيليّة على المنطقة “ج” (حوالي 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربيّة) تمكّن من مراقبة الأراضي الزراعيّة و مسالك التنقل و موارد المياه، هذا إضافة إلى الأراضي التي تم استغلالها عبر المستوطنات، وهي مناطق لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق النموّ الذي ينتظره الاقتصاد الفلسطيني.
لا تفصح صفقة القرن شيئا عن الحصار البري و اليحري الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيليّ حول قطاع غزّة منذ أكثر من 12 سنة. خاصّة أنّ هذه المنطقة التي يتمّ قصفها باستمرار دون مجهود يذكر في إعادة الإعمار تعدّ أكثر المناطق كثافة سكّانيّة على المستوى العالميّ. لقد ناهزت نسبة البطالة في هذه المنطقة 53 بالمائة و نسبة الفقر المتصاعدة للسكان ، الذين يشكّل المهاجرون 80 بالمائة منهم، أثارت المخاوف نحو الأسوأ لدى الأونروا التي تحدّثت عن الوضع في المنطقة كعلامة واضحة ل”فشل سياسيّ”.
نظّم اتفاق “باريس” لسنة 1994 (الجانب الاقتصاديّ من اتفاق أوسلو) إدماج الاقتصاد الفلسطيني ضمن دائرة اقتصاد دولة الاحتلال. فهذه السوق الأسيرة لفائض الإنتاج الإسرائيلي، لا تمتلك السيطرة اللازمة على أراضيها لتطوير زراعاتها فضلا عن تطوير نشاطها الصناعيّ. و قد أخفى المفاوضون الإسرائيليون بدهاء هذا المنع عبر إجراءات متعلّقة بالمجال الأمني: فمن يتحدث عن الصناعة ، يتحدث بداهة عن خطر صناعة الأسلحة.
أما عن قطاع الخدمات ، فيخضع هو الآخر إلى تبعيّة واسعة للسلطات الإسرائيليّة. و يمكن أن نضرب مثلا حول ذلك استعمال شبكة 3Gفي مجال الاتصالات الهاتفيّة و الذي استمرّ حظر استعمالها حتى جانفي 2018.و لتعزيز سيطرتها، أضحت إسرائيل السلطة المكلفة بإسداء تراخيص للتوريد و التصدير من و إلى الأراضي الفلسطينيّة إضافة لتحصيل الآداءات. و يخضع إسداء المبالغ الناتجة عن هذه العمليّات بالطبع إلى تقلّبات العلاقة مع السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ، التي تعتمد ميزانيّتها بشكل كبير على هذه الموارد.
و كان لهذه الهيمنة الإسرائيليّة نتيجة أخرى تضاف إلى السيطرة التامّة على الحياة الاقتصاديّة الفلسطينيّة. حيث مكّنت إسرائيل من الاستفادة من أكثر من 60 بالمائة من قيمة المساعدات المقدّمة للفلسطينيّين سواء كان ذلك عن طريق المساعدة المباشرة للسكّان أو الإعانات المقدّمة للسلطة الفلسطينيّة أو المنظمات غير الحكوميّة. لتصبح إسرائيل بالتالي الغانم الأوّل من المساعدات المقدّمة للفلسطينيين. ممّا يحيلنا إلى القول تبعا لذلك بأن إسرائيل ستكون القوّة الاقتصاديّة الأبرز التي ستنتفع مباشرة من ضخ مبلغ ال50 مليار دولار على مدى العشر سنوات القادمة، في صورة تجسّدت الصفقة الأمريكيّة على أرض الواقع.
بنشرها للبرنامج الاقتصاديّ للصفقة كتمهيد للجانب السياسي، لا تقوم الإدارة الأمريكيّة سوى بتغذية النقاش حول برنامجها المفترض للسلام. فهي تقوم بإزاحة الأسباب السياسيّة للضعف الاقتصاديّ الفلسطيني، المرتبطة أساسا باستمرار ممارسات الاحتلال، لتضع محلّها أسطورة الإمكانيّات الاقتصاديّة الفلسطينية القادرة على توفير “الازدهار” الاقتصادي من دون قيام الدولة. و بما أنها لا تلبّي رغبات أيّ من طرفي النزاع ، فلا يلوح أيّ أمل لتحقيق هدف الصفقة المفترض و المتمثّل في إرساء “سلام دائم”. بل هي في مقابل ذلك تسعى بشكل معلن شيئا فشيئا إلى تعزيز التقارب الاقتصاديّ بين إسرائيل و دول الخليج تحت غطاء مفاوضات السلام.
أيّ مستقبل للحلول الدبلوماسيّة ؟
تستعيد الوثيقة المقترحة من الإرادة الامريكيّة التوصيات (و كذلك الرسوم، انظر في ذاك تغريدات “جويل برونو” Jeol Braunold في تويتر حول الموضوع) التي قدّمتها بعض الوكالات الاقتصاديّة وكبرى المنظمات غير الحكوميّة. و برفضها الإشارة إلى المسألة السياسية، في علاقة بالاحتلال الإسرائيلي، فإن الدبلوماسيّة توجّه رصاصها في المكان الخطأ . ما هو دورها؟ ما هي “قيمتها المضافة” (في استعارة للمعجم الاقتصادي) تجاه رهانات التنمية و الدفاع و تعزيز القطاع الخاص إذا تمّ إفراغها من كلّ محتوى سياسي يتعلٌّق بنقاشات السلم و الحرب؟ فبعدم قدرتها على تنظيم نقاش حول الحل تبقى دبلوماسيّة المال عاجزة في مواجهة كلّ معارضة و كلّ مطالبة سياسيّة.
و بحجّة مرافقة الفلسطينيّين في مسارهم نحو السلام و النماء بالالتفاف على مشروع الدولة، فإن هذه المبادرة الأمريكيّة تطرح العديد من الأسئلة التي تتجاوز إطار الصراع العربي -الإسرائيليّ. إذ أنّ ترامب يواصل ، بل يعزّز من السلوك الأمريكيّ المهمّش للمؤسّسات الدوليّة، و يساند بشكل غير معقول نظاما يتمّ اتهامه مرارا بارتكاب جرائم الحرب، بتغليبه لسلطة السلاح و المبالغ الكبيرة على الدبلوماسيّة الحقيقيّة. و كما أنّ هذا السلوك أمريكي ، فهو يمكن أن يكون أيضا روسيّا أو فرنسيّا أو سعوديا ، حيث يساهم بشكل واضح، و أيا كان مصدره في عديد الكوارث الأخرى في المنطقة، سواء في ليبيا و سوريا و اليمن.
فالدبلوماسيّة إلى حدّ هذا المستوى تكرّس منهج اللاعقاب ضد الإسرائيليّين. و السياسة الأمريكيّة ترتكز على الاعتقاد بأنّ وعدا ب50 مليار دولار كفيل لوحده بإسكات كل مطالبة فلسطينية بإرساء الدولة و الحق في السيادة الوطنيّة. إنّ هذا المرور من محاباة الطرف الأقوى إلى نفي وجود أي حقوق أساسيّة حتى، للطرف الضعيف، يعدّ منعرجا خطيرا لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، إذ بذلك ندفن تماما أيّ أمل في تحقيق سلام حقيقيّ، يضمن كرامة الشعوب بالدرجة الأولى.
اكسافيي غينيار : مختصّ في العلوم السياسية ، باحث بمركز “نوريا”
ترجمه خير الدين باشا من فريق بر الأمان.